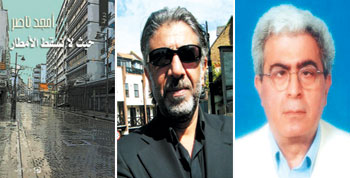 «في لندن التي أقيم فيها الآن بقناع شخص وهمي فارًّا من نبوءة أمي التي يرنُّ فيها اسمي الأول كذكرى مفزعةٍ «يا يحيى لن تعرفَ نفسُك الراحة» من الصعب، على كل حال، أن يستلقي المرءُ على سطح بيته القرميدي المائل ويعدُّ نجوماً هجرت مواقعها».
«في لندن التي أقيم فيها الآن بقناع شخص وهمي فارًّا من نبوءة أمي التي يرنُّ فيها اسمي الأول كذكرى مفزعةٍ «يا يحيى لن تعرفَ نفسُك الراحة» من الصعب، على كل حال، أن يستلقي المرءُ على سطح بيته القرميدي المائل ويعدُّ نجوماً هجرت مواقعها».
بهذا المقطع ينهي أمجد ناصر القصيدة الأولى في مجموعته الأخيرة « حياة كسرد متقطع». الآسر في هذه المجموعة هو الوصول إلى عمق شعرية السرد. حيث يتشكّل الشعر من تلاوين الحياة وقد امتزجت بأسطورتها، ومن قدرة اللحظة على أن تتكثف، لتصير اختصاراً للزمن.
ليس هدف هذه المقدمة تحليل ديوان شعري احتل موقعه الخاص في خريطة الشعر العربي المعاصر. لكن أمجد ناصر أخطأ حين اعتقد أن أفضل من يقدم روايته الأولى إلى القارئ يجب أن يكون روائياً. فالسرّ الذي لا يصدقني أحد حين أبوح به، هو أن ما يأسرني في الأدب، قدرة الكلام على تلخيص الزمن. وهذا لا يقوم به سوى الشعر. لذا لجأت شهرزاد إلى تطعيم حكاياتها الساحرة بالشعر، كي تثبّت المعاني، كأن الكلمة الشعرية مسمار ندقه على حائط الزمن. ولذا قام الروائيون منذ سرفانتيس بتحويل السرد لحظات شعرية متتابعة، كي يكون في وسع الحكاية أن تلتقط نبض الأشياء وهمساتها السريّة.
عندما أعدت قراءة «حياة كسرد متقطع»، اكتشفت أن وصول أمجد ناصر إلى الرواية كان مسألة وقت. فالشاعر الذي ملأ فجوات الزمن بالقصيدة، لا بد أن يصل إلى كتابة الزمن. والزمن مخادع وبطيء، على الرغم من سرعة تقلباته. يكفي أن نعيد قراء قصيدة «فتاة في مقهى كوستا»، كي نكتشف أن الحكاية التي سنقرؤها في هذا الكتاب بدأت هناك، حين خرجت الفتاة من القصيدة وجلست أمام الشاعر، لتروي لنا عن «القصيدة التي فكّرت بقصيدة أخرى وكتبتها».
عندما بدأت بقراءة هذا الكتاب، شممت رائحة تلك البلاد التي يطلق عليها أمجد ناصر اسم «الحامية». هذه الرائحة لم تخرج من جلدي، منذ ذهابي إلى عمّان، بعد الهزيمة الحزيرانية، بحثا عن أفق ارتسم في المدينة التي انحفرت في ذاكرتي في وصفها مدينة بيضاء. والذاكرة مراوغة، وهي كما سنرى في هذه الرواية أيضا، ابنة الخيال، أو اسمه الثاني، أو صورته في مرايا الزمن. لكن أمجد ناصر لا يروي حكاية الأردن، بل يستخدم عبير الذاكرة من أجل أن يكتب رواية ممتعة وعميقة عن تجاويف الزمن، وحكمة العمر الذي ذاب في الغربة.
قد يجد القارئ في هذه الرواية حكاية عن النظام العربي، وعن نظام معارضته أيضاً، وهذا صحيح. فالمشرق العربي بأسره، عاش تجارب تحويل الوهم حقائق سياسية واجتماعية صارت راسخة. وأنا أستثني هنا مصر، لأن تاريخها الحديث مختلف، رغم أنها صارت الآن تشبه «الحاميات» الأخرى، في كل شيء تقريباً.
هذه القراءة ليست خاطئة، وقد تكون ضرورية، كجزء من قراءة تحولات الوعي العربي، وفهم المتغيرات الكبرى التي قادت إلى انقلاب المفاهيم، في زمن صعود التيارات الأصولية.
لكنني لا أميل إلى هذه القراءة. سحر هذا النص يكمن في التباساته وفجواته، وفي المثنى الذي يتوهج فيه، جاعلا من السرد الروائي بنية محكمة، تكتمل بالنقصان، وتنتشي بحنين لا يسقط في غواية الحنين، بل يشرب مراراته حتى الثمالة.
اعتقدت في البداية أنني أمام ما يشبه المذكرات، لأكتشف أن ما بدا لي بنية مذكراتية لم يكن سوى خدعة. الرواية تستخدم مقترب «السرد الذاتي»، تروي بسيرة المتكلم، وبطل الحكاية شاعر وكاتب ينقسم إلى نصفين: يونس وأدهم. يونس هو الاسم الحقيقي وأدهم هو الاسم المستعار الذي يوقّع النصوص. هذا الانقسام، الذي يبدو للوهلة الأولى وكأنه تجسيد لشخصية الكاتب الحقيقية، سرعان ما يتلاشى، حين نكتشف الشخصيات الأخرى في الكتاب، وحين نشعر أن انقسام الأنا، هو بنية الرواية وليس ذريعتها. مقترب السرد الذاتي، جرى استخدامه كثيراً في الأدب العربي المعاصر. غالب هلسا الذي أطلق على معظم أبطاله اسم غالب، قد يكون رائد هذا المقترب، لكن ما يجمع رواية أمجد ناصر إلى رواية «سلطانة»، لهلسا، أكثر عمقا من هذا المقترب الشكلي. ما يجمعهما هو رائحة المكان، وعبير الذاكرة التي تقاوم مزقها بالكتابة.
يفتح النص السردي أبوابه منذ اللحظة الأولى. رحلة عودة يونس أو أدهم إلى وطنه، بعد غربة امتدت عشرين عاما، تشكّل مفتاح الذاكرة. نحن أمام ذاكرة تعيد تركيب الماضي، لا من أجل استعادته، أو رثائه، بل في وصفه مرآة للذات. يونس يقف أمام هذه المرآة ليجد أمامه شخصا آخر. ورلى، لا تستعاد في وصفها حباً أبدياً لا يزول، بل تستعاد في وصفها إمّاً للانقسام الذي سيطاول ابن الراوي. يونس الذي تزوج في الجزيرة بعد الرحيل الكبير من مدينة الحصار، سوف يسمّي ابنه بدرا، على اسم الشاعر العراقي الكبير الذي يحب، وحين يعود إلى «الحامية»، سيكتشف أن رلى أطلقت على ابنها الأول الاسم نفسه، في لحظة تلتبس فيها العلاقات والمعاني، بحيث لا ندري هل يونس هو والد بدر الثاني، وهل انقسام البطل إلى شخصيتين سوف يستمر في ابنين يحملان الاسم نفسه؟
ليس من تقاليد المقدمات كتابة النقد، لكنني وجدت نفسي وأنا أقرأ هذا النص وأعيد قراءته ممتلئاً بالكلام عنه. وهذا ناجم عن سحر ما أحب أن أطلق عليه اسم «شعرية الرواية».
شعرية الرواية، لا علاقة له بما يمكن أن نسميه الرواية الشعرية، التي تحشو النص السردي بتأملات مشعرنة لا معنى لها. إنها نتاج نثر منضبط، يقتصد ويسترسل، كي يروي. وحين ينجح النص في رواية حكاياته، فإنه يفتح شهية القارئ على روايتها من جديد، وبأشكال متعددة. شعرية الرواية تفتح أبواب الحكاية التي لا نهاية لها، وتأخذنا في رحلة إلى عالم تنتفي فيه الفروق بين الحقيقة والخيال، وبين الذاكرة والحلم.
«مدينة اللاأين»، التي سيقع عليها القارئ عند أمجد ناصر، هي المكان الذي يتقاطع فيه الخط العربي، بالشعر، بالعودة إلى اللامكان. أي إنها مكان روائي بامتياز، وإطار نرى فيه ليست خيانة الأفراد وحيرتهم فقط، بل خيانة الزمن، وتقلباته، ووحشية التاريخ.
تنتهي الرواية أمام المقبرة، يونس الفتى، (وهو ابن شقيق يونس الخطّاط) يقود عمه إلى المقبرة، من أجل زيارة الموتى. لا يقول لنا الراوي ماذا قال للموتى، ولا يروي ما سمعه منهم. لكن هذه الرواية، كأي عمل أدبي حقيقي وكبير، تحاور الأحياء، كي تفتح نافذة الحوار مع الموتى، جاعلة من عودة بطل الرواية إلى بلاده، رحلة أخرى إلى المجهول.
-
+
- لندن